loading ad...
عمان- في زمن تتسارع فيه وتيرة التكنولوجيا وتتداخل حدود العلم والدين والفلسفة، يصدر كتاب "تأملات مسافر عبر الزمن- مقالات قصيرة" للدكتور فراس صلاح جرار، ليأخذ القارئ في رحلة ذهنية تأملية تتجاوز المألوف.اضافة اعلان
يجمع الكتاب الذي عمل على تحريره نورس زياد أبو الهيجاء. بين عمق الطرح وبساطة الأسلوب، ويطرح أسئلة شائكة تتعلق بمصير الإنسان، وحدود المعرفة، ومستقبل التكنولوجيا، من منظور شخصي وتجربة أكاديمية ثرية.
من خلال مقالات قصيرة، يستعرض جرار، الأستاذ المشارك في جامعة الحسين التقنية، تساؤلات جريئة مثل: هل يمكن للآلة أن تفكر؟ وهل توجد إشارات للطيران أو التكنولوجيا في النصوص الدينية؟ كما يتناول قضايا النهضة الصناعية، ومفاهيم الهندسة، والعلاقة بين العقل الاصطناعي والبشري. لا يزعم الكتاب تقديم أجوبة نهائية، لكنه يحفز القارئ على التفكير الحر، ويعيد ترتيب الأسئلة بعيون جديدة تبحث عن المعنى في تقاطع العلم بالروح.
يسعى المؤلف في هذا الكتاب إلى تحفيز القارئ على التفكير في قضايا عصرية مهمة، من خلال طرح تساؤلات جريئة مثل: "هل ستزول التكنولوجيا قبل نهاية العالم؟"، "هل توجد إشارات إلى الطائرات في القرآن الكريم؟"، "خريطة الطريق للنهضة الصناعية العربية"، "الهندسة الصناعية وخلق الإنسان"، "الذكاء الاصطناعي– هل يمكن للآلة أن تفكر؟"، "هل توجد تكنولوجيا في الجنة؟"، إلى جانب مواضيع تأملية أخرى.
في مقدمة الكتاب، يوضح الدكتور جرار أن هذا العمل عبارة عن مجموعة خواطر وتأملات تراكمت لديه على مر السنين، يحاول من خلالها إيجاد إجابات لأسئلة لطالما حيرته، ولم يجد لها رأيا شافيا. معظم هذه الأسئلة ترتبط بشكل أو بآخر بالتكنولوجيا والتعليم، وهي نابعة من شغفه بالعلم، وتجربته الأكاديمية في مجال الهندسة الميكانيكية. ومع مرور الوقت، كون تصورا خاصا أحب أن يشاركه مع من قد تراودهم تساؤلات مشابهة.
ويضيف المؤلف أن معظم هذه المقالات نشرت سابقا على موقعه الإلكتروني خلال السنوات الماضية، لكن حبه للكتاب المطبوع دفعه إلى جمعها في مؤلف يسهل تداوله والاحتفاظ به على رفوف المكتبات، آملا أن تنفض عنه الأجيال القادمة غبار النسيان وتستفيد من محتواه. ويختم مقدمته بتمنياته بأن يجد القارئ في هذه الخواطر فائدة ومتعة.
على غلاف الكتاب كتب الناشر سمير اليوسف مقدمة يشير فيها إلى أن هذا الكتاب يعد تجربة ذهنية ووجدانية تتجاوز حدود الزمان والمكان. يأخذنا الدكتور فراس صلاح جرار في رحلة تأملية تتقاطع فيها التكنولوجيا مع الدين، والعلم مع الخيال، والماضي مع المستقبل. من خلال مقالات قصيرة تنبض بالفضول والأسئلة العميقة، يناقش موضوعات مثل الهندسة الصناعية، الذكاء الاصطناعي، وخرائط النهضة العربية، ويقدم تأملات قرآنية معاصرة حول مفاهيم الطيران والاتصالات وأشكال الحياة في الجنة، بأسلوب يجمع بين السلاسة والعمق.
في هذا الكتاب لا يقدم المؤلف إجابات نهائية، بل يفتح نوافذ للتفكير ويثير رغبة صادقة لإعادة النظر في مفاهيم مألوفة بعيون جديدة. إنه أشبه برحلة فكرية نعيد من خلالها ترتيب الأسئلة التي نطرحها على العالم من حولنا، وربما على أنفسنا أيضا. كتاب يطرح أسئلة جريئة ويقدم رؤى غير تقليدية في قالب تأملي يناسب المهتمين بالتقاطع بين الفكر العلمي والروحي.
في إحدى المقالات التي يتناولها الكتاب، بعنوان "الذكاء الاصطناعي: هل يمكن للآلة أن تفكر؟"، يستعرض المؤلف بدايات الحديث عن الذكاء الاصطناعي، التي تعود إلى منتصف القرن العشرين حين نشر العالم البريطاني "آلان تورينغ" ورقته الشهيرة "الآلة الحاسوبية والذكاء"، التي شكلت حجر الأساس في هذا المجال. يشير جرار إلى أن هذه التقنية تعتمد على محاكاة الشبكات العصبية في دماغ الإنسان، وأن تطبيقاتها اليوم أصبحت واسعة الانتشار وتشمل الترجمة، والتعرف إلى الوجوه، والقيادة الذاتية للسيارات، والتعرف على الكلام، ورسم الخرائط، وإجابة الاستفسارات على الهاتف، وتشخيص الأمراض، وتقديم الاقتراحات في برامج الكتاب، أو على صفحات الإنترنت، ولعب الشطرنج.
يستذكر جرار محطة فارقة في تاريخ الذكاء الاصطناعي العام 1997، حين هزم برنامج "ديب بلو" بطل العالم في الشطرنج "غاري كاسباروف، بفضل قدرته على تجربة ملايين السيناريوهات. ويتساءل المؤلف: هل يمكن للآلة أن تكون ذكية فعلا؟ هل يمكنها أن تفكر؟.
"تمتلك برامج الذكاء الاصطناعي بعض الخصائص التي يمكن اعتبارها ذكية، إذ لديها القدرة على التعلم والاستنتاج. فعند تغذيتها بعدد كبير من الأمثلة المرتبطة بظاهرة معينة، تصبح قادرة على التنبؤ بنتائج جديدة عند تقديم مدخلات مشابهة. ولا شك أن في هذه القدرة نوعا من الذكاء، حيث يمكنها ربط المعطيات المختلفة واستنتاج نتائج أو تحقيق أهداف محددة. إلا أن هذه البرامج، في الوقت ذاته، لا تمتلك وعيا بالطبيعة الفيزيائية للظاهرة التي تتعامل معها".
"يحتاج الذكاء الحقيقي، في جوهره، إلى عنصرين أساسيين: الإرادة والإدراك، وهما ما لا تستطيع أي آلة امتلاكهما، لا الآن ولا في المستقبل المنظور. فعلى سبيل المثال، عندما يقوم برنامج ذكاء اصطناعي بترجمة نص معين، فإنه لا يدرك معناه، بل يعتمد على تقنيات إحصائية ومعالجة كميات ضخمة من البيانات لإنجاز المهمة. إضافة إلى ذلك، فإن هذه البرامج لا تملك القدرة على تحديد أهدافها أو برمجة نفسها ذاتيا، مما يجعل وصفها بـ"الذكية" وصفا غير دقيق لطبيعتها الفعلية".
"وعلى أي حال، يمتلك العقل البشري خصائص وقدرات فريدة تعجز الحواسيب عن مجاراتها، مثل المرونة في التعامل مع المشكلات المتنوعة، والقدرة على تحديد الأولويات، والقيام بالقفزات الابتكارية، والتخيل. كما يتميز الإنسان بقدرات يصعب تفسيرها علميا مثل الحدس والإلهام، وهي سمات ما تزال خارج نطاق فهم الآلة أو محاكاتها".
"وبعيدا عن هذا الجدل الفلسفي، فإن ما يعرف بالذكاء الاصطناعي يعد اليوم تكنولوجيا لا غنى عنها في مختلف مجالات الحياة. ورغم أن كفاءة الحواسيب ما تزال دون مستوى الأداء البشري من حيث الفهم والإدراك، فإن سرعتها الكبيرة في معالجة وتخزين المعلومات تجعلها مثالية لتنفيذ العديد من المهام التي قد تكون مملة أو مرهقة للإنسان. فما قد يستغرقه البشر أشهرا من العمل، يمكن إنجازه في غضون ساعات باستخدام هذه الأنظمة الذكية".
"لقد شكلت أفلام الخيال العلمي في أذهاننا صورة نمطية مرعبة عن الذكاء الاصطناعي، حيث رسمت سيناريوهات مخيفة عن مستقبل تسيطر فيه الآلات على العالم وتشن الحروب على صانعيها من البشر. إلا أن الواقع بعيد تماما عن تلك التصورات، فالذكاء الاصطناعي يحمل في طياته فوائد وإمكانات هائلة. وكما مثلت المحركات امتدادا لقدرة الإنسان الجسدية على الحمل والتنقل، يمكن النظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره امتدادا لقدراته العقلية في الحساب والاستنتاج. تنويه: تم إنشاء الرسوم والتوضيحات الواردة في هذا الكتاب، بما في ذلك تصميم الغلاف، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي".
"يحتوي الكتاب أيضا على مقال بعنوان "الهندسة الميكانيكية"، يروي فيه جرار قصة شخصية فيقول: "لن أنسى خيبة الأمل التي ارتسمت على وجه جدتي، رحمها الله، عندما علمت أنني قررت دراسة الهندسة الميكانيكية بدلا من الطب، رغم أن معدلي في الثانوية العامة كان يؤهلني للالتحاق بكلية الطب. قالت لي: (بدك تصير تصلح سيارات يا ستي). كانت صدمة لم تقتصر على جدتي، بل شملت أقرباء وأصدقاء كثيرين. والسبب في ذلك يرجع إلى التصور السائد عن هذا التخصص، حيث يربطه كثيرون بميكانيكا السيارات فقط".
"عندما أتحدث عن الهندسة الميكانيكية، أول ما يخطر على بال الكثيرين هو ميكانيكا السيارات. ورغم أن السيارات تعد من أعظم الأمثلة على تصميمات الميكانيك، إلا أن هندسة السيارات تمثل جزءا صغيرًا من هذا التخصص الواسع، الذي يعتبر من أقدم وأشمل فروع الهندسة".
"ولتوضيح الصورة بشكل أفضل، لا بد من الرجوع إلى أصل التسمية. ورغم أن مصطلح الهندسة الميكانيكية ظهر لأول مرة خلال الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، إلا أن أصوله اللغوية تعود إلى ما قبل ذلك بكثير. فكلمة "ميكانيك" ترتبط بالآلات (Machines)، بينما كلمة "الهندسة" بالإنجليزية (Ingenium) تعود إلى الكلمة اللاتينية (Engineering)، التي تعني الذكاء".
"وفي الحضارة العربية، كان يطلق على الهندسة الميكانيكية اسما أكثر تعبيرًا، وهو "علم الحيل". ولماذا هذا الاسم؟ لأن هذا المجال يعتمد على استخدام الحيلة، التي تعني الفطنة والعقل في التدبير وتصميم الآلات والصناعة".
وبالتالي سواء باللغة الإنجليزية أو العربية، فإن جوهر هندسة الميكانيك يكمن في استخدام العقل والذكاء لابتكار الوسائل والآلات التي تساهم في تقليل الجهد البشري المطلوب لتنفيذ الأعمال المختلفة، أو حتى لتعويض غيابها تماما.
لقد أصبح اليوم التطور في هذا المجال أحد المعايير الأساسية لنجاح الأمم وتقدمها، ومن أبرز أسباب الرخاء الاقتصادي للدول. وتظل الهندسة شغفي الأكبر، والعلم الذي أحب تعلمه وتعليمه، رغم أنني حتى اليوم لا أملك المهارة في إصلاح السيارات.
يجمع الكتاب الذي عمل على تحريره نورس زياد أبو الهيجاء. بين عمق الطرح وبساطة الأسلوب، ويطرح أسئلة شائكة تتعلق بمصير الإنسان، وحدود المعرفة، ومستقبل التكنولوجيا، من منظور شخصي وتجربة أكاديمية ثرية.
من خلال مقالات قصيرة، يستعرض جرار، الأستاذ المشارك في جامعة الحسين التقنية، تساؤلات جريئة مثل: هل يمكن للآلة أن تفكر؟ وهل توجد إشارات للطيران أو التكنولوجيا في النصوص الدينية؟ كما يتناول قضايا النهضة الصناعية، ومفاهيم الهندسة، والعلاقة بين العقل الاصطناعي والبشري. لا يزعم الكتاب تقديم أجوبة نهائية، لكنه يحفز القارئ على التفكير الحر، ويعيد ترتيب الأسئلة بعيون جديدة تبحث عن المعنى في تقاطع العلم بالروح.
يسعى المؤلف في هذا الكتاب إلى تحفيز القارئ على التفكير في قضايا عصرية مهمة، من خلال طرح تساؤلات جريئة مثل: "هل ستزول التكنولوجيا قبل نهاية العالم؟"، "هل توجد إشارات إلى الطائرات في القرآن الكريم؟"، "خريطة الطريق للنهضة الصناعية العربية"، "الهندسة الصناعية وخلق الإنسان"، "الذكاء الاصطناعي– هل يمكن للآلة أن تفكر؟"، "هل توجد تكنولوجيا في الجنة؟"، إلى جانب مواضيع تأملية أخرى.
في مقدمة الكتاب، يوضح الدكتور جرار أن هذا العمل عبارة عن مجموعة خواطر وتأملات تراكمت لديه على مر السنين، يحاول من خلالها إيجاد إجابات لأسئلة لطالما حيرته، ولم يجد لها رأيا شافيا. معظم هذه الأسئلة ترتبط بشكل أو بآخر بالتكنولوجيا والتعليم، وهي نابعة من شغفه بالعلم، وتجربته الأكاديمية في مجال الهندسة الميكانيكية. ومع مرور الوقت، كون تصورا خاصا أحب أن يشاركه مع من قد تراودهم تساؤلات مشابهة.
ويضيف المؤلف أن معظم هذه المقالات نشرت سابقا على موقعه الإلكتروني خلال السنوات الماضية، لكن حبه للكتاب المطبوع دفعه إلى جمعها في مؤلف يسهل تداوله والاحتفاظ به على رفوف المكتبات، آملا أن تنفض عنه الأجيال القادمة غبار النسيان وتستفيد من محتواه. ويختم مقدمته بتمنياته بأن يجد القارئ في هذه الخواطر فائدة ومتعة.
على غلاف الكتاب كتب الناشر سمير اليوسف مقدمة يشير فيها إلى أن هذا الكتاب يعد تجربة ذهنية ووجدانية تتجاوز حدود الزمان والمكان. يأخذنا الدكتور فراس صلاح جرار في رحلة تأملية تتقاطع فيها التكنولوجيا مع الدين، والعلم مع الخيال، والماضي مع المستقبل. من خلال مقالات قصيرة تنبض بالفضول والأسئلة العميقة، يناقش موضوعات مثل الهندسة الصناعية، الذكاء الاصطناعي، وخرائط النهضة العربية، ويقدم تأملات قرآنية معاصرة حول مفاهيم الطيران والاتصالات وأشكال الحياة في الجنة، بأسلوب يجمع بين السلاسة والعمق.
في هذا الكتاب لا يقدم المؤلف إجابات نهائية، بل يفتح نوافذ للتفكير ويثير رغبة صادقة لإعادة النظر في مفاهيم مألوفة بعيون جديدة. إنه أشبه برحلة فكرية نعيد من خلالها ترتيب الأسئلة التي نطرحها على العالم من حولنا، وربما على أنفسنا أيضا. كتاب يطرح أسئلة جريئة ويقدم رؤى غير تقليدية في قالب تأملي يناسب المهتمين بالتقاطع بين الفكر العلمي والروحي.
في إحدى المقالات التي يتناولها الكتاب، بعنوان "الذكاء الاصطناعي: هل يمكن للآلة أن تفكر؟"، يستعرض المؤلف بدايات الحديث عن الذكاء الاصطناعي، التي تعود إلى منتصف القرن العشرين حين نشر العالم البريطاني "آلان تورينغ" ورقته الشهيرة "الآلة الحاسوبية والذكاء"، التي شكلت حجر الأساس في هذا المجال. يشير جرار إلى أن هذه التقنية تعتمد على محاكاة الشبكات العصبية في دماغ الإنسان، وأن تطبيقاتها اليوم أصبحت واسعة الانتشار وتشمل الترجمة، والتعرف إلى الوجوه، والقيادة الذاتية للسيارات، والتعرف على الكلام، ورسم الخرائط، وإجابة الاستفسارات على الهاتف، وتشخيص الأمراض، وتقديم الاقتراحات في برامج الكتاب، أو على صفحات الإنترنت، ولعب الشطرنج.
يستذكر جرار محطة فارقة في تاريخ الذكاء الاصطناعي العام 1997، حين هزم برنامج "ديب بلو" بطل العالم في الشطرنج "غاري كاسباروف، بفضل قدرته على تجربة ملايين السيناريوهات. ويتساءل المؤلف: هل يمكن للآلة أن تكون ذكية فعلا؟ هل يمكنها أن تفكر؟.
"تمتلك برامج الذكاء الاصطناعي بعض الخصائص التي يمكن اعتبارها ذكية، إذ لديها القدرة على التعلم والاستنتاج. فعند تغذيتها بعدد كبير من الأمثلة المرتبطة بظاهرة معينة، تصبح قادرة على التنبؤ بنتائج جديدة عند تقديم مدخلات مشابهة. ولا شك أن في هذه القدرة نوعا من الذكاء، حيث يمكنها ربط المعطيات المختلفة واستنتاج نتائج أو تحقيق أهداف محددة. إلا أن هذه البرامج، في الوقت ذاته، لا تمتلك وعيا بالطبيعة الفيزيائية للظاهرة التي تتعامل معها".
"يحتاج الذكاء الحقيقي، في جوهره، إلى عنصرين أساسيين: الإرادة والإدراك، وهما ما لا تستطيع أي آلة امتلاكهما، لا الآن ولا في المستقبل المنظور. فعلى سبيل المثال، عندما يقوم برنامج ذكاء اصطناعي بترجمة نص معين، فإنه لا يدرك معناه، بل يعتمد على تقنيات إحصائية ومعالجة كميات ضخمة من البيانات لإنجاز المهمة. إضافة إلى ذلك، فإن هذه البرامج لا تملك القدرة على تحديد أهدافها أو برمجة نفسها ذاتيا، مما يجعل وصفها بـ"الذكية" وصفا غير دقيق لطبيعتها الفعلية".
"وعلى أي حال، يمتلك العقل البشري خصائص وقدرات فريدة تعجز الحواسيب عن مجاراتها، مثل المرونة في التعامل مع المشكلات المتنوعة، والقدرة على تحديد الأولويات، والقيام بالقفزات الابتكارية، والتخيل. كما يتميز الإنسان بقدرات يصعب تفسيرها علميا مثل الحدس والإلهام، وهي سمات ما تزال خارج نطاق فهم الآلة أو محاكاتها".
"وبعيدا عن هذا الجدل الفلسفي، فإن ما يعرف بالذكاء الاصطناعي يعد اليوم تكنولوجيا لا غنى عنها في مختلف مجالات الحياة. ورغم أن كفاءة الحواسيب ما تزال دون مستوى الأداء البشري من حيث الفهم والإدراك، فإن سرعتها الكبيرة في معالجة وتخزين المعلومات تجعلها مثالية لتنفيذ العديد من المهام التي قد تكون مملة أو مرهقة للإنسان. فما قد يستغرقه البشر أشهرا من العمل، يمكن إنجازه في غضون ساعات باستخدام هذه الأنظمة الذكية".
"لقد شكلت أفلام الخيال العلمي في أذهاننا صورة نمطية مرعبة عن الذكاء الاصطناعي، حيث رسمت سيناريوهات مخيفة عن مستقبل تسيطر فيه الآلات على العالم وتشن الحروب على صانعيها من البشر. إلا أن الواقع بعيد تماما عن تلك التصورات، فالذكاء الاصطناعي يحمل في طياته فوائد وإمكانات هائلة. وكما مثلت المحركات امتدادا لقدرة الإنسان الجسدية على الحمل والتنقل، يمكن النظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره امتدادا لقدراته العقلية في الحساب والاستنتاج. تنويه: تم إنشاء الرسوم والتوضيحات الواردة في هذا الكتاب، بما في ذلك تصميم الغلاف، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي".
"يحتوي الكتاب أيضا على مقال بعنوان "الهندسة الميكانيكية"، يروي فيه جرار قصة شخصية فيقول: "لن أنسى خيبة الأمل التي ارتسمت على وجه جدتي، رحمها الله، عندما علمت أنني قررت دراسة الهندسة الميكانيكية بدلا من الطب، رغم أن معدلي في الثانوية العامة كان يؤهلني للالتحاق بكلية الطب. قالت لي: (بدك تصير تصلح سيارات يا ستي). كانت صدمة لم تقتصر على جدتي، بل شملت أقرباء وأصدقاء كثيرين. والسبب في ذلك يرجع إلى التصور السائد عن هذا التخصص، حيث يربطه كثيرون بميكانيكا السيارات فقط".
"عندما أتحدث عن الهندسة الميكانيكية، أول ما يخطر على بال الكثيرين هو ميكانيكا السيارات. ورغم أن السيارات تعد من أعظم الأمثلة على تصميمات الميكانيك، إلا أن هندسة السيارات تمثل جزءا صغيرًا من هذا التخصص الواسع، الذي يعتبر من أقدم وأشمل فروع الهندسة".
"ولتوضيح الصورة بشكل أفضل، لا بد من الرجوع إلى أصل التسمية. ورغم أن مصطلح الهندسة الميكانيكية ظهر لأول مرة خلال الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، إلا أن أصوله اللغوية تعود إلى ما قبل ذلك بكثير. فكلمة "ميكانيك" ترتبط بالآلات (Machines)، بينما كلمة "الهندسة" بالإنجليزية (Ingenium) تعود إلى الكلمة اللاتينية (Engineering)، التي تعني الذكاء".
"وفي الحضارة العربية، كان يطلق على الهندسة الميكانيكية اسما أكثر تعبيرًا، وهو "علم الحيل". ولماذا هذا الاسم؟ لأن هذا المجال يعتمد على استخدام الحيلة، التي تعني الفطنة والعقل في التدبير وتصميم الآلات والصناعة".
وبالتالي سواء باللغة الإنجليزية أو العربية، فإن جوهر هندسة الميكانيك يكمن في استخدام العقل والذكاء لابتكار الوسائل والآلات التي تساهم في تقليل الجهد البشري المطلوب لتنفيذ الأعمال المختلفة، أو حتى لتعويض غيابها تماما.
لقد أصبح اليوم التطور في هذا المجال أحد المعايير الأساسية لنجاح الأمم وتقدمها، ومن أبرز أسباب الرخاء الاقتصادي للدول. وتظل الهندسة شغفي الأكبر، والعلم الذي أحب تعلمه وتعليمه، رغم أنني حتى اليوم لا أملك المهارة في إصلاح السيارات.











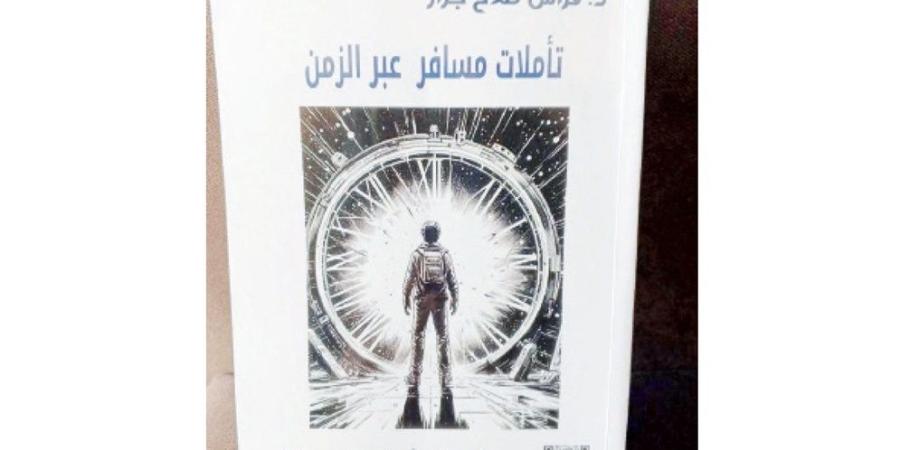






0 تعليق